منذ أن نطق الإنسان أولى كلماته، كان يتوسل
اللغة لتشكيل المعنى، لا مجرد التعبير عنه. وفي قلب هذا التوسل، ينبثق سؤالٌ عميق:
هل نحن نتعلم اللغة، أم نولد بها؟ بين رؤية تعتبر اللغة انعكاسًا لبنية عقلية
مشتركة، وأخرى ترى فيها أداة تشكيل للوعي، تتصارع نظريتان: نحو كلي كامن في الدماغ
كما يقترحه تشومسكي، ومفهوم إدراكي نسبي تؤسس له فرضية سابير-وورف. وفي هذا
الصراع، تنكشف اللغة ليس فقط كوسيلة تواصل، بل كمرآة لرؤية الذات والعالم.
السؤال
عن وجود بنية عميقة مشتركة بين اللغات يُثير جدلًا فلسفيًّا ولغويًّا عميقًا بين
النظريات الكونية (مثل تشومسكي) والنظريات النسبية (مثل سابير-وورف).
1. موقف تشومسكي: النحو الكوني
أ. الفرضية الأساسية
يوجد في العقل البشري قواعد لغوية فطرية
مشتركة تُشكّل "بنية عميقة" تسبق تعلم أي لغة محددة. هذه البنية تشرح:
1. سهولة اكتساب الأطفال للغات معقدة رغم ضعف
المدخلات.
2. تشابه التراكيب النحوية بين لغات العالم
(مثل: وجود الفاعل/المفعول به في جميع اللغات).
ب. أمثلة على القواعد الكونية
1. التكرارية: قدرة اللغات على تضمين جمل
داخل جمل (مثل: "الرجل [الذي يرتدي قبعة] جاء").
2. التمايز بين الأسماء والأفعال: موجود حتى
في لغات قبائل الأمازون مثل "بيرهها".
ج. انتقادات النظرية
1. تنوع اللغات: بعض اللغات تخلو من تراكيب
موجودة في أخرى (مثل: لغة "بيرهها" لا تستخدم التكرار).
2. إهمال العوامل الثقافية: التركيز على
البنية المجردة يتجاهل دور المجتمع في تشكيل اللغة.
2. فرضية سابير-وورف: النسبية
اللغوية
أ. الفكرة الرئيسية
اللغة تُشكّل الفكر والإدراك، وليس هناك بنية
عالمية.
الاختلافات بين اللغات تعكس اختلافًا في تصور
العالم:
مثال: لغة "هاوبا" لا تميز بين
الماضي والمستقبل، مما يؤثر على مفهوم الزمن عند متحدثيها.
مثال: لغة "الإسكيمو" لها مصطلحات
متعددة للثلج، مما يُحسّن تمييزهم لأنواعه.
ب. دراسات داعمة
تجربة كاي وكوندون
متحدثو الإنجليزية يرون الألوان مختلفة
(أزرق/أخضر) أكثر من متحدثي لغة "تاراهومارا" (التي لا تميز بينهما
لغويًّا).
ج. انتقادات الفرضية
1. مبالغة في التأثير: الفرق في الإدراك ليس
جذريًّا كما زُعم.
2. إغفال المشتركات: حتى اللغات المختلفة
تشارك مفاهيم أساسية (مثل: السببية، المكان).
3. نظريات وسيطة: التوفيق بين
الكونية والنسبية
أ. نموذج إيفانز
هناك نواة مشتركة (مثل: العلاقات النحوية
الأساسية)، لكن التفاصيل تختلف ثقافيًّا.
مثال: جميع اللغات تميز بين
"الفاعل" و"المفعول"، لكن بعض اللغات تسمح بحذف الضمائر (مثل:
اليابانية).
ب. نظرية توماسيلو
1. المشترك بين اللغات ليس قواعد فطرية، بل
قدرات عقلية عامة (مثل: التعاون، فهم النوايا).
2. اللغة تطوّرت كأداة تواصل اجتماعي، لا
كنظام مغلق.
4. أدلة حديثة من العلوم
المعرفية
أ. دراسات تصوير الدماغ
مناطق معينة (مثل: منطقة بروكا) تنشط في
معالجة اللغة لدى جميع البشر، بغض النظر عن اللغة الأم.
ب. اللغات المختلطة (الكريول)
عندما تختلط لغات مختلفة، تظهر قواعد مبسطة
تتبع أنماطًا مشتركة (يدعم فكرة "فطرة لغوية").
ج. الاستثناءات المثيرة للجدل
لغة "بيرهها"
1. لا تستخدم التكرار، ولا الأعداد، ولا
الألوان المجردة.
2. تشومسكي يعتبرها شذوذًا، بينما يراهن
آخرون على دحض نظريته.
تساؤلات مفتوحة
1. هل الاختلافات بين اللغات سطحية أم
جوهرية؟
2. كيف نفسر لغات الإشارة التي تطورت
تلقائيًّا (مثل: لغة الإشارة النيكاراغوية)؟
3. هل الذكاء الاصطناعي قادر على اكتشاف
"بنية عميقة" لو تعلّم آلاف اللغات؟
في النهاية، تبدو اللغة وكأنها وعيٌ مُتجسد:
فهي تمتلك بنيةً داخلية توحّد البشر، ومعانٍ خارجية تفرّقهم. إن إدراكنا للعالم لا
ينفصل عن الطريقة التي نعبّر بها عنه، ولا يتحرر من القوالب اللغوية التي تعيد
تشكيله. وهكذا، تصبح اللغة أكثر من مجرد أصوات ومعاني، بل فضاءً فلسفيًا تتلاقى
فيه الطبيعة والاختيار، الفطرة والثقافة، العمق والاختلاف. إنها ليست فقط ما
نقوله، بل كيف نتكون من خلال ما نقول.
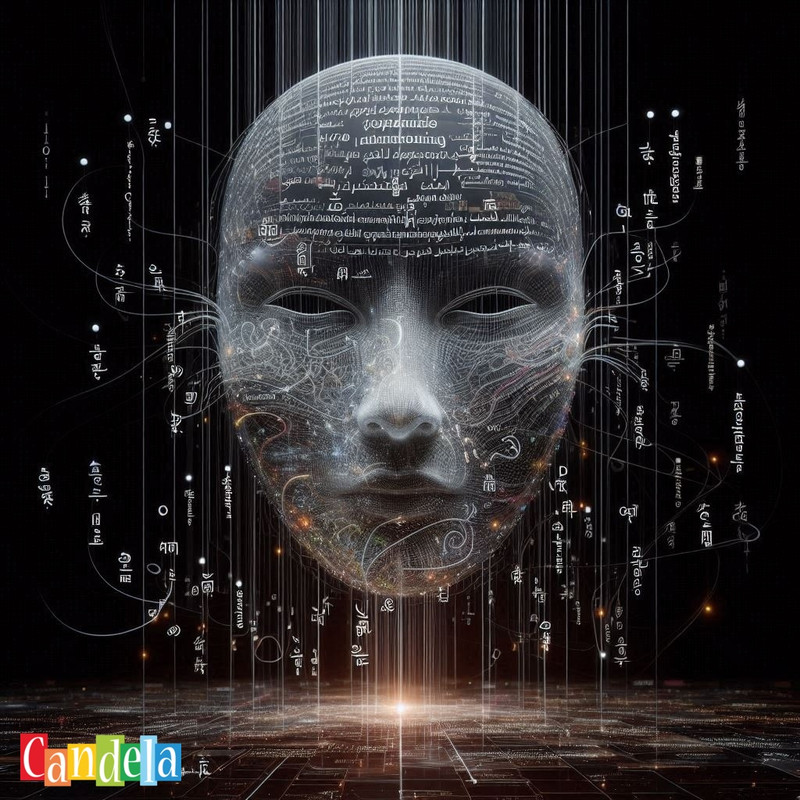

تعليقات: (0) إضافة تعليق